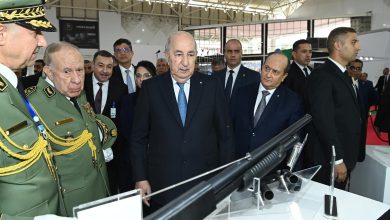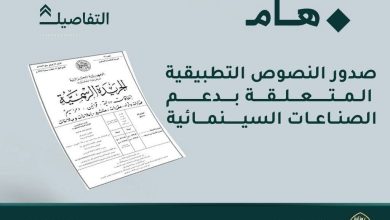وطني
ثورة نوفمبر المجيدة… نضال شعب لاستعادة أرض أجداده المسلوبة

وأج
شكل الفاتح نوفمبر 1954 يوما حاسما في تاريخ الجزائر، حيث انطلقت شرارة ثورة عظيمة سطرت فصولها بالدماء والتضحيات لاستعادة أرض الأجداد المسلوبة وإنهاء عهد من القهر والاستبداد استمر طيلة 132 سنة.
كانت حرب التحرير بمثابة كفاح وجودي للدفاع عن الأمة الجزائرية وهويتها وأرضها الموروثة عن الأسلاف في مواجهة استعمار وحشي سعى باسم نشر “الحضارة” إلى إخضاع الشعب الجزائري بترهيبه وسفك دماء أبنائه.
وكانت ذريعة نشر”الحضارة” سخيفة، خاصة وأن انتشار التعليم بين الجزائريين في ذلك الوقت كان أعلى بكثير منه في أوساط الشعب الفرنسي، حيث يشير القائد كلود أنطوان روزي في كتابه “رحلة في الجزائر عام 1833” إلى أن “جميع الرجال تقريبا كانوا يعرفون القراءة والحساب”، بينما في فرنسا “كان 40 بالمائة من السكان أميين”.
من الناحية الاقتصادية، لم يكن ازدهار الجزائر قبل الاستعمار محل شك، إذ تميزت البلاد آنذاك بثراء مواردها الزراعية وتنوع منتجاتها المحلية، بل إن هذه الموارد مكنت الجزائر من تحقيق فائض زراعي سمح بتزويد بعض دول البحر الأبيض المتوسط، بما فيها فرنسا التي كانت مدينة للجزائر بمبالغ هائلة مقابل كميات القمح الكبيرة التي كانت تحصل عليها.
وكان السعي وراء ثروات الجزائر وخيراتها أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا الاستعمار الدموي الذي مارس سياسة الترهيب ضد الجزائريين من أجل تجريدهم من أرضهم، مثلما تؤكده التقارير العسكرية وشهادات جنود المحتل الذين عايشوا الأحداث في تلك الحقبة، والتي لا تكشف إلا جزءا ضئيلا من جرائم الحرب التي ارتكبت ضد الشعب الجزائري.
وصدرت أوامر من الماريشال بوجو ضد المقاومين الجزائريين، خاصة ضد رمز المقاومة الوطنية، الأمير عبد القادر، تتضمن استخدام أسلوب الأرض المحروقة الذي كان يعتمد على تدمير المحاصيل وتخريب القرى، مما أسفر عن مقتل الآلاف من الجزائريين، بما فيهم النساء والأطفال.
وفرض إرهاب الاستعمار تغييرا في التركيبة البشرية للبلاد، إذ أجبر أصحاب
الأرض على الانتقال للعيش في مناطق قاحلة بعيدة عن جذور أجدادهم الخصبة، ليحل محلهم المعمرون الأوروبيون.
وأعطى الاستعمار طابعا مؤسساتيا لمصادرة الأراضي باعتماد قوانين تسهل مصادرتها مثل قانون فارنيي لعام 1873 الذي سمح للمستوطنين بالاستيلاء على الأراضي على نطاق واسع لفائدة المعمرين.
وفي غضون قرن من الزمن، استولى السكان الأوروبيون، الذين كانوا يمثلون 10 بالمائة فقط من إجمالي الساكنة، على نحو 3 ملايين هكتار من الأراضي الخصبة، بينما كان 9 ملايين من الجزائريين يعيشون على زراعة الكفاف.
علاوة على ذلك، استحدث المستوطنون أساليب جديدة للإنتاج الزراعي تقوم على الاستغلال التوسعي والمكثف للموارد الطبيعية على حساب الطرق التقليدية المتوارثة للفلاحين الجزائريين.
وعمل المعمرون على استبدال المحاصيل التقليدية والمنتجات المحلية بمحاصيل ريعية صممت لتعزيز الاقتصاد الفرنسي، أهمها الكروم، ما أدى إلى تدمير تدريجي للاكتفاء الذاتي المحلي من الغذاء وتفاقم الجوع والبؤس لدى الجزائريين.
وكما لو أن نهب الأراضي لم يكن كافيا، فرضت السلطات الاستعمارية ضرائب جائرة على المزارعين الجزائريين، ما أدى إلى تفاقم وضعهم المزري مقابل استفادة المعمرين من الإعانات والضرائب المخففة.
وفي هذا الجو المشحون بالاضطهاد، اشتعلت شرارة الثورة في 1 نوفمبر 1954 وانتشرت في ربوع الوطن، معلنة ميلاد حركة منظمة تناضل من أجل الاستقلال والتحرر من قبضة الاستعمار، وأصبحت المناطق الريفية التي دمرتها عقود طويلة من الاستعمار أحد الساحات الرئيسية لهذه الحرب من أجل الكرامة، المدفوعة بالأمل في استعادة الأرض المنهوبة والعودة إلى رخاء الأمس.
واليوم، أصبح هذا الريف نفسه أحد ضمانات الأمن الغذائي والتقدم الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وذلك بفضل الإصلاحات المختلفة التي قامت بها السلطات العمومية بعد الاستقلال، بدءا بالثورة الزراعية في السبعينيات التي أطلقها الرئيس الراحل هواري بومدين.
ومنذ ذلك الحين، تمكنت الجزائر من التغلب على سنوات الجفاف الطويلة من خلال
استعادة أمنها الغذائي وسيادتها تدريجيا، محققة نتائج مرضية بشكل ملموس، وهو ما تؤكده أحدث التقارير الدولية، بما في ذلك تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، الذي صنف الجزائر في المرتبة الأولى عربيا وأفريقيا من حيث الأمن الغذائي.
ولا تزال نضالات الماضي تلهم حاضرا مفعما بالفخر والأمل، تتطلع من خلاله الجزائر إلى مستقبل واعد، معتمدة كليا على شبابها لمواصلة الكفاح من أجل التقدم الذي بدأ منذ 71 عاما.